|
|
|
كان سؤال والدي استنكاريًا لا استفهاميًا.
|
|
لن أردد العبارة النمطية "لم يؤمن والدي بموهبتي يومًا"، هو فقط لم يؤمن بالكتابة مصدرًا لكسب الرزق.
|
بصراحة أكبر، لم يكن يُلقي بالًا للكُتب أصلًا؛ عدا الكتب المدرسية طبعًا.
|
|
لذا، أنزعج حين رأني أقرأ كتابًا عن حرفة الكتابة، فأعلن عن انزعاجه بالعبارة إياها.
|
كانت إجابتي التلقائية: "نعم"
|
لا أعلم كيف خرجت منيّ هذه الـ"نعم"؛ ربما لأن الكتابة كانت -ولا زالت- وسيلة تواصلي مع العالم.
أو لأن والدي استطاع إسكات صوتي، لكنه لم يتمكن من رصد كلماتي.. التي أبقيتها بعيدة عن ناظريه؛ كل تلك الاعتراضات الجامحة والشتائم الحانقة لم يسمعها، إذ ظلّت حبيسة دفاتري.
|
هذا التعريّ مؤلم، وقد ظننتي تشافيت.
|
أخبرت استشاريتي النفسية أنني غفرت لوالديّ، حين رأيتهما "ضحايا". أثنت على رؤيتي، ثم نطقت بالعبارة التي انتظرتها طويلًا وأثلجت صدري:
|
|
|
|
لكن هذا لا يُبرر ما فعلاه معك!
|
|
صحيح. لا شيء يشرح هذا الدمار الذي أحياه بسببهما، والذي جعلني أخجل حتى من ألمي؛ أليس لهذا السبب كنت أنوء بأوجاع العلاج الكيماوي وحدي؟
|
بالعودة إلى حديثي مع الاستشارية النفسية (والذي سأفرد له حديثًا في تدوينة كما عهدتموني)، فقد سألتني ضمن اللقاء الأول عن أسماء الأدوية الموصوفة ليّ لعلاج الاكتئاب. بحثت في هاتفي (وقد كنت أحتفظ بصورة لها).. لكنني لم أجد شيئًا، ثم تذكرت أنني استخدمت الصورة في إحدى تدويناتي..
|
فشاركتها التدوينة؛ لتقرأ ما كتبته أولًا، ولأُجيب عن سؤالها ثانيًا.
فأرسلت ليّ الرد الآتي:
|
|

|
|
ثم اكتشفت أن العالم الحقيقي موحش فعلًا.
|
وأن حلم امتلاك مكتبة (أو محل قرطاسية) ليس ورديًا، وإنما يعني -كذلك- احتكاكًا مباشرًا مع الناس، ناضجين ومراهقين وأطفالًا.
|
كان ذلك مرهقًا.
لم يكن كذلك بادئ الأمر، على العكس.. كنت استمتع كلما جاء زبون ليشتري قلمًا أو يسأل عن رواية، وكنت أدوّن طلبات الزبائن لأجلبها من السوق (كل 3 أيام).
|
إنما لنعد لبداية القصة.
بعد تنقلي لمساحات عمل مشتركة عدّة، ومعاناتي المختلفة في كل منها (انقطاع الكهرباء - انقطاع النت - الضجيج غير المُحتمل .. وحتى إغلاق المكان بعد إفلاسه!)، قررت وضع كل مدخراتي في مشروع المكتبة.
|
|

|

|
لم ألقُ بالًا لقلة الأصناف التي تمكنت من شراءتها، إذ صببت تركيزي على الهدف الأعظم: التفرغ للعمل الحرّ.
|
|
علمت أن (حركة البيع) لن تكون قوية. خاصةً وأنني بدأت متأخرًا عن (الموسم=بداية العام الدراسي)، لكنني اعتبرت ذاك من مصلحتي.. أقصد قلة الزبائن. إذ سيتسنى ليّ التركيز على المشاريع.
|
|
|
مشاريع لم تأتِ أصلًا!
يمضي اليوم ببطء. صحيحٌ أنني أنشغل بالتدوين، لكنني أشعر أنني أكتب بلا طائل، وذاك جانب من جوانب حياة الكاتب المظلمة (سأتحدث عن البقية في حلقة البودكاست المنتظرة مع دليلة).
|
|
وأعدّ نقودي آخر اليوم، وأُجري بعض الحسابات، لأكتشف أن العمل في المكتبة بلا طائل أيضًا!
|
|
علاوة على ذلك، كانت الصورة الذهنية التي حملتها أفضل من الواقع بألف مرة. إذ يتحلى الناس بطباعٍ غريبة.
وكثيرًا ما وقفت اتسائل: ما الذي أفعله هنا بالضبط؟ هل غدوت -فجأة- ترسًا في عجلة الاستهلاك؟
لكنني أعود لأقنع نفسي: أنت لا تبيع كماليات، بل تبيع فرحة .. وأقلامًا تصنع مستقبلًا.
|
|
ثم أنني حين قررت تأثيث المكتبة، اشتريت أثاثًا مُستعملًا، وتلك كانت صرختي الصامتة والاعتراضية في وجه المجتمع الاستهلاكي.
|
|

|

|
|
مجتمع، لم أعد أفهمه.. أو ربما لم أكن أفهمه أصلًا! فسواء أكان دينيًا أو عدميًا، فالمآل واحد.
|
لكنني فكرت: أنا بحاجة للاندماج مع المجتمع، وسماع قصصه وخفاياه وأسراره السفلية، وفكرة المكتبة تضمن ذلك.
|
صحيحٌ أنني حزت محبة الناس سريعًا، لكن كل ما افكر به: الانعزال. لكن كيف أفعلها وأنا ربّ أسرة؟
|
كان حلم المكتبة سفينة النجاة بالنسبة ليّ، شعرت بها تتحطم. لكن المشكلة ليست في المكان، كما ظننت. المشكلة بين جنبيّ.
|
|
وهكذا، وجدت نفسي مع مواجهة شرسة أخرى مع الأفكر الانتحارية. وباعتبار تجاربي مع الطب النفسي لم تكن مبشّرة، قررت الالتجاء للاستشارات النفسية. لا أودّ "حرق" التدوينة، لكن بالمجمل، لم أُحقق استفادة.
|
حسنًا، قالت المستشارة النفسية أن تغيّر الحال يحتاج وقتًا، لكنني أصلًا في سباقٍ من الزمن. هي تعلم ذلك، ولذا شددّت على مسألة تقريب مواعيد الجلسات (لكن الجلسات تكلّف ثروة، وأنا لا أملك المال. يبدو أن التاريخ يُعيد نفسه، أو بالأحرى أنا مَن لا أتطور!)
|
|
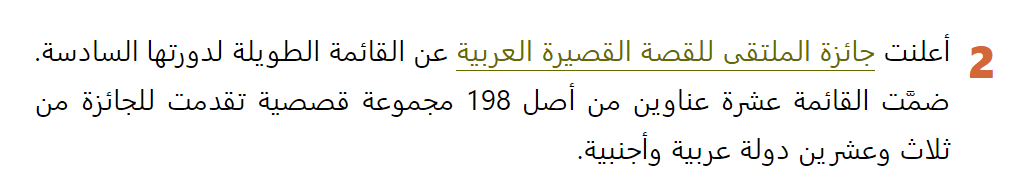
|
تحسّرت على نفسي: متى آخر مرة كتبت أو نشرت قصة قصيرة؟
|
|
منذ 4 سنوات! في مجلة (الهلال)
|
|

|

|
وذلك رغم ما تمتلئ به حياتي من قصص تستحق أن تُروى!
|
|
لكنني ذاهلٌ عن العالم، في ذات الوقت أتعامل مع ضرباته المستمرة؛ تقلباتي المزاجية، فكرة الموت، فكرة الانتحار، أؤمن تارة وأكفر تارة.
|
|
|
كتبت هذه الفقرة على مدار شهر، وحرت ماذا أبقي وما أحذف منها. النشرة ككل مبعثرة ومجزأة، إنما أصررت على نشرها في موعدها. لأنني اعتدت من الحياة أن تمنحني المفاجأت كلما يئست.
|
|
|
|
|
|
|
انعكاس 📼
|
إن كنت تواجه صعوبة في إيجاد وقت للكتابة، فمتأكد أن الفيديو الآتي سيُعجبك
|

|
|
|
|
|

|
هل يمكن تبيّن اسم الفِلم من الصورة أعلاه؟
بالطبع لا!
|
حسنًا، إنه فِلم (Corner Office). هذا أولًا..
أما ثانيًا، فالفِلم.. كيف أصفه؟ .. لنقل أنه يُشبه ضربة خفيفة على الرأس.
(أورسون) موظف مُغترّ بنفسه، ومُدمن عمل في بيئة لا تقدّر المواهب، يكتشف مكتبًا مُنعزلًا؛ مثالي لشخصيتيه الفريدة. بحيث كلما دخله تضاعفت إنتاجيته.
عيب المكتب الوحيد: لا أحد يراه سوى صديقنا أورسون!
|
الجميع يُنكر وجوده .. ويُطالب (أورسون) بفعل المثل. وحين يرفض، تطرده إدارة الشركة.
|
|
ما الذي يحاول الفِلم قوله؟
|
ربما تكون الإجابة، بحسب تصنيف الفِلم (كوميديا سوداء عبثية Absurdist black comedy): لا شيء!
|
لكن، من منظوري أنا، يقول الفِلم الكثير.
في مشهد غرفة الاستراحة، حيث يوجد مصباح يتطلب التبديل. تعبير عن الانشغال بالصغائر؛ كان بمقدور (أورسون) تبديل المصباح بنفسه، لكنه ظلّ يشتكي من إهمال الآخرين.
|
|
يقول أن مكتب يضم 5-6 موظفين، أيعقل ألا يوجد من بينهم شخص رشيد؟
|
لن نناقش مسألة: لماذا لم يستبدله هو؟ فالقضية الحقيقية أننا نعيش فعلًا في عالم أناني، يبحث عن مصلحته فحسب، ويصبّ جلّ اهتمامه على تقديم الحد الأدنى من كل شيء.
|
على عكس أورسون، الذي لم يكتفي بإنجاز عمله، بل مضى يُنجز مهام الآخرين، وكانت إدارته مسرورة إلى أن علمت بمكان إنجازه العمل: مكتب الزاوية إياه.
|
|
[بالمناسبة، هل أخبرتك أن مكتبتي تقع على الناصية/الزاوية؟]
|
|
|
|
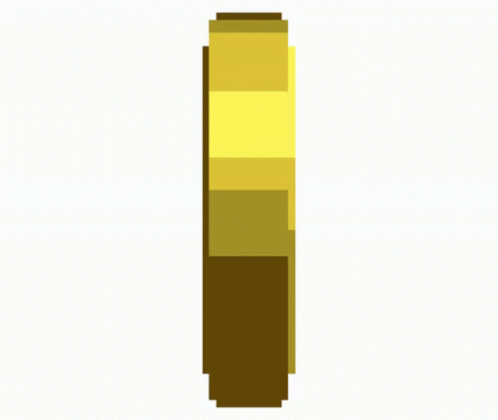
|