هل تذكر حين سألتك إن مررت بموقف صعب بحيث دفعك للتفكير في الاستسلام فحسب؟ صدّق أو لا تصدّق، مرّ عام على سؤالي! على العموم، أنا هنا لأرجوك ألّا تستسلم، وأتمنى أن تُلهمك قصتي التالية.
عندما كنت مراهقًا يبلغ من العمر 17 عامًا. لم أحلم -من أعماقي- بممارسة كرة القدم الجامعية فحسب، بل أردتها كمنحة دراسية.
وكنت قد أنهيت دراستي الثانوية من ضمن 30 طالبًا، في بلدة تضم 500 طالبًا في الثانوية؛ لم يلعب أحدهم لصالح فريق جامعي. بلغة الأرقام، كان حلمي.. مستحيلًا!
لن أُطيل عليك.
قيل لي -مرارًا وتكرارًا- من زملائي والأهالي:
يا صاح! أنت لست جيدًا كفاية للعب كرة القدم الجامعية، ولست متفوقًا بحيث تحصل على منحة دراسية لكرة القدم.
أنت تضيّع وقتك فحسب.
ومع ذلك، أصررت على التمرّن يوميًا، وواصلت استعداداتي لألعاب القوى الجامعية.
نحن على مركبٍ واحد
بدا الأمر كما لو كان قاربي الشراعي جاهز للانطلاق ثم أسمع أحدهم يقول: “لا يمكنك الإبحار“. أو “هل أنت متأكد من أن هذا ما تودّ فعله؟” ومع كل اعتراض يُطلقه، ينتكس شراعك شيئًا فشيئًا. إلى أن تجده، مع تكرر الأمر، قد تسطّح بالكامل.
أنت لا تتحرك، لقد انتهى أمرك. ولا أستطيع إخبارك بعدد المرات التي أردت فيها أن أُنهي المسألة؛ تمنيت لو أنني توقفت عن المحاولة ليصمت هؤلاء الحمقى.
لكنني لم أتوقف (رغم أنني فكرت كثيرًا في الاستسلام)، كنت أكثر هدوءًا بشأن ما أنتوي فعله وهنا مربط الفرس؛ وجدت أنه إذا لم يكن لدي هدف يفهمه الناس، فمن الأفضل أن أصمت.
فأنا أنتمي لبلدة صغيرة، وبصراحة تامة، لا يمتلك الناس أي فكرة عما أفعله. وحتى لو حاولت أن أشرح، فلن يفهموا.
تعلمت وأتقنت فن الصمت
قد تجد مَن يفهمك ويُدرك تمامًا ما تحاول فعله. لكن، ولأصدقك القول، فهم -على الأرجح- ليسوا عائلتك بل ولا حتى المحيطين بك.
وجدت هؤلاء القلة الذين يدعمونني حقًا، وأحطت نفسي بهم، ثم شاركتهم التقدم الذي أحرزته. أظن أن ذاك ما أبقى على حماسي، علمًا بأنني لم أخبر عداهم بأي شيء.
إن سألني شخصٌ ما، من خارج دائرة الداعمين، عمّا أفعله في حياتي. فأُجيبه: أسوّق عبر الانترنت، ثم أبادره بالسؤال عمّا يفعله هو. وهكذا أُبعد الحرج عن كلينا؛ لست مضطرًا لإبهار أحد، أليس كذلك؟
بالعودة إلى القصة
لكم تمنيت لو لم أخبر زملائي -أو البالغين- في تلك المدينة أنني أسعى للعب كرة القدم الجامعية. كان الأفضل -بكثير- لو أغلقت فمي وبذلت قصارى جهدي في صالة الألعاب الرياضية.
لحُسن الحظ، هذا ما بدأت بفعله في النهاية وتحسّنت أموري على إثره كثيرًا.
أفضل جزء من القصة
في كانون الثاني (يناير) من سنة دراستي الثانوية الأخيرة، توافد العديد من المدربين في الجامعة إلى مدرستي لرؤيتي، حتى أن المدير أجلسني في مكتبه وسألني: لماذا يأتي هؤلاء إلى مدرستنا؟
أجبته: “بصراحة، لم أكن أعرف أن هذا سيحدث. سأحاول معرفة ما يمكنني فعله“.
كانت إحدى أفضل اللحظات في حياتي عندما تلقيت -في يناير- منحة دراسية لكرة القدم.
هل سارت الأمور على ما يُرام حقًا؟

ذات مرة، دخلت قاعة الحواسيب، فإذ بأحد أصدقائي يعرض أمامي مقالًا هجوميًا.. عني!
في تلك اللحظة، هل تتخيّل رغبتي الشديد في الاستسلام، وقول: تبًا لهذا؟!
ولكنني لم أستسلم وأقسم بالله أنني أردت ذلك بشدّة. كان الأمر يستحق الاستسلام!
أطرف ما حدث، والذي يمكن أن أضحك منه الآن، كان (مأدبة الكبار Senior banquet)، حيث نحتفل بكل الإنجازات التي حققناها في مسيرتنا المهنية في المدرسة الثانوية.
في الغالب، تشهد تلك المواقف تصفيقًا حادًا للطلاب الذين حصلوا على منحة أكاديمية.
كنت أحد لاعبي كرة القدم القلائل ممن حصلوا على منحة، وأعتقدت أن حضور المأدبة سيكون رائعًا؛ لأنه الناس هناك سيكونون سعداء من أجلي. بذلت جهدًا كبيرًا في برنامج كرة القدم للمدرسة وساعدتها في الحصول على أربع بطولات.
حضر زميلي في الكلية من أجلي. وضجّ المكان بالهتافات والتصفيق للحاصلين على منحهم الدراسية.. عدا شخص واحد: أنا! لم يصفقوا لي حتى عندما اعتليت المنصة، نعم، لقد مشيت إلى هناك في صمت، وذلك رغم أن جميع الطلاب -الذين جاءوا قبلي وبعدي- تلقوا تصفيقًا.
كانت تلك لحظة قاتلة؛ اعتقدت أنهم يحبونني وسيقفون في صفيّ.
لكنها، في الآن ذاته، اللحظة التي قررت السخرية منهم (في عقلي)، وعدم السماح لهم باختطاف بهجتي، يمكنهم فقط الجلوس ومشاهدتي أسيطر على العالم، لأنه..
إذا كنتم تعجزون -حتى عن التصفيق من أجلي- بسبب شعوركم بالغيرة أو الجنون أو الغضب أو الارتباك أو أي شيء آخر، فست مُضطرًا لقضاء ثانية إضافية في التفكير بكم.
ومجددًا، هل فكرت في الاستسلام آنذاك؟ قطعًا! كان من المغري حقًا نسيان حلمي، والعودة لبلدتي الصغيرة للعمل في مصنع.
سيفعل الكثيرون ذلك لأنه أسهل وأكثر أمانًا. ولكن أتعلم؟ (الخيارات الآمنة) ليست سبب وجودنا على هذه الأرض. أليس كذلك؟
“عائلتي لا تفهم ما أفعله”
وعائلتي كذلك، لأن البعض يشعر بالغيرة والبعض الآخر بالحرج.
في البداية كان الأمر مدمرًا نوعًا ما، أنتم عائلتي، ألا يجب أن تكونوا مهتين بالتحدث معي حول حلمي ودعمي؟
لكن لا تسير الأمور على هذا النحو، لذا فكل ما فعلته هو أنني لم أعد أتحدث معهم حول هذا الموضوع بعد الآن.
لم أتخلى عنهم، إنما تخليت عن محاولة حملهم على فهم ودعمي فيما أفعله. عدلت عن محاولة إقناعهم وكان الأمر أسهل بكثير بهذه الطريقة. وهكذا، لم أعد مضطرًا للتعامل مع الإحراج والغيرة والأشياء الغريبة بعد الآن. شيء مذهل. صحيح؟
هذه هي رسالتي لهذا اليوم. آمل أن تصلك كما ينبغي. لا تستسلم عند العقبات الصغيرة، اتفقنا؟ أحبكم يا رفاق.
هل تمانعون لو شاركتكم رسالة شخص رائع؟ من أجل كل كاتب وصانع محتوى!
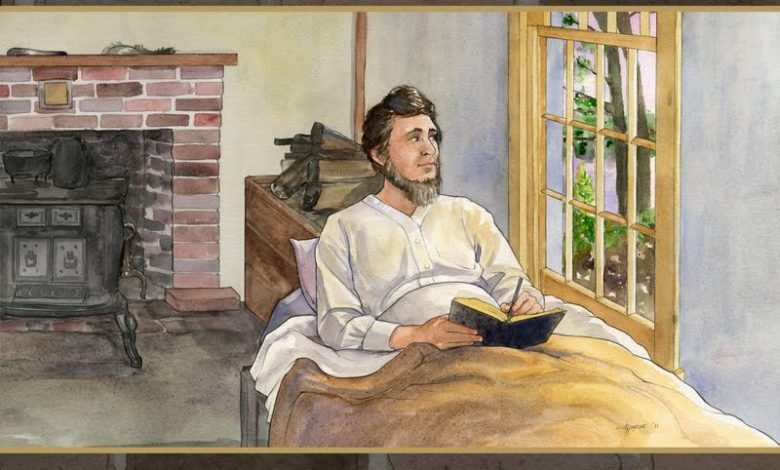
تدوينة رائعة وملهمة أستاذ طارق جاءت في وقتها شكراً لك 🌹🙏
تعليقك يعني ليّ الكثير.. لأنني ترددت قبل نشر التدوينة
ممتنٌ للطفك حقًا
دايمًا تبهرني بتدويناتك، بتجاربك، بقوة صبرك وتحملك، بجلدك وعدم تخاذلك، كلما أحسست أني ضعفت، أو مللت، أو توانيت، أو تهاونت، آتي إلى مدونتك، يكفيني منها تدوينة كي أشحذ الهمة مجدّدًا، شكرًا لوجودك واستمرارك أخي طارق.
جاء تعليقك بلسمًا آ. عفاف،👩🏽⚕️
ولم أنسى يومًا -في عزّ ضعفي- وصفك إيايّ بمُلهمك لهذا العام ✨
الشكر، كل الشكر، لوجودك وتعليقك الذي أثلج صدري.